انواع مصادر المعرفة
نعيش
في هذه الأيام عصر الانترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فمن خلال وسائل
الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي التي جعلت من هذا الكوكب الفسيح قرية صغيرة، حيث
تنوعت وتعددت أنواع مصادر المعرفة في عصرنا الحالي الذي يعد بحق عصر الانفجار
المعرفي وعصر تكنلوجيا المعلومات، ومن تلك المصادر التي أشار اليها (جيدوري,
2017) التي يمكن من
خلالها انتاج المعرفة والحصول عليها وهي:
1) الإنسان
2) فرق العمل
3) البحوث والدراسات
الانسان: لقد أثبت
الإنسان في كل العصور أنه الأكثر قدرة على الابتكار والإبداع، حيث تجلى إبداع
الإنسان عبر عصور تاريخية مهمة حددها (Toffler) في كتابه "حضارة
الموجة الثالثة" وفق نموذج الموجات الثلاث:
-
فالموجة الأولى
تتمثل بالثورة الزراعية قبل عشرة آلاف سنة.
-
والموجة الثانية
بالثورة الصناعية التي بدأت قبل ثلاثمائة سنة.
-
في حين تمثلت
الموجة الثالثة بثورة المعلومات التي لا تزال مستمرة.
ويلاحظ (جيدوري,
2017) على هذا التطور
أنه في كل عصر كانت تتنامى فيه قاعدة الثروة المعرفية وقاعدة المعلومات المتراكمة
أكثر من العصر أو العصور التي سبقته، وهذا ما أدى إلى تنامي قدرة الإنسان على
التطور والتحكم فيه أكثر، والأهم من ذلك تنامي قدرة الإنسان على الابتكار
والإبداع، وهذا ما أشار إليه (Toffler) في كتابه "صدمة المستقبل" بقوله: " إن ما عُرف
خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة عن طبيعة الكائنات الحية لا يمكن أن يقارن بضآلة ما
اكتشف خلال أي مدة مماثلة طوال تاريخ الجنس البشري". وهذا يعني أن سرعة
التغير الذي تشهده المجتمعات البشرية أدى إلى تطورات معرفية كمية وكيفية، أصبح من
اللازم مواجهتها بتربية جديدة تكون قادرة على مواكبة هذه التغيرات، كما فعلت
الولايات المتحدة الأمريكية عندما أعلنت في تقريرها "أمة في خطر"، بعد
أن توصلت اللجنة التي أعدت التقرير إلى تخلف التعليم الأمريكي عن مواكبة مستجدات
عصر العلم والثورة العلمية.
فرق
العمل: ويقصد بهم مجموعة من العاملين ضمن مجال وظيفي معين أو مجالات مختلفة،
يتميزون بقدرات إبداعية ويعملون معا لابتكار معارف جديدة في مجال عملهم، ويعد (Ben Wood) الذي كان مساعدا لـ (Thorndike) وهو من أشهر الذين أصلو
لفكرة فرق العمل البحثية، حيث أشرف على العديد من الدراسات ومشروعات البحوث، وكان
قائداً متميزا لحركة البحث العلمي من أجل إنتاج المعرفة.
البحوث
والدراسات: تعد البحوث والدراسات العلمية مصدرا مهماً لإنتاج المعرفة، حيث أنها
تسهم في إيجاد معرفة جديدة يكون لها دور فعال في تطوير أنشطة المؤسسات المختلفة،
كما هو الحال في الدول المتقدمة التي تعتمد في بناء اقتصادها على إنتاج المعرفة في
المجالات العلمية المختلفة.
ويضيف
(جيدوري,
2017) أن (Cullen) قد قسم مصادر المعرفة
إلى مصدرين أساسيين هما:
a) المصادر الخارجية: ومن أمثلتها: المكتبات والانترنت، والقطاع
الذي تعمل فيه المنظمة والمنافسون لها، والموردون والزبائن والجامعات ومراكز البحث
العلمي وغيرها.
b) المصادر الداخلية: ومن أمثلتها: المؤتمرات الداخلية، المكتبات
الالكترونية، التعلم الصفي، الحوار، العمليات الداخلية عبر الذكاء والعقل والخبرة
والمهارة، أو من خلال التعلم بالعمل أو البحوث.
ونحن
في هذه الورقة ومن خلال المقدمة السابقة سوف نتعرض بالشرح لأنواع مصادر المعرفة من
خلال المحاور التالية:
Ø
مفهوم أنواع مصادر المعرفة.
Ø
أهمية أنواع مصادر المعرفة
Ø
أنواع وتقسيمات مصادر المعرفة.
Ø
المنظور الفلسفي لأنواع مصادر المعرفة.

مفهوم أنواع مصادر المعرفة:
عرف كثير من الباحثين مصادر المعرفة، الا أنهم لم يتفقوا على تعريف
واضح ومحدد لمصادر المعرفة ولعلنا نورد بعضا منها وأهمها ما يلي:
يعرفها (نصر,
2001) بأنها تلك
المصادر التي يستقي منها الباحثون والدارسون ومتخذو القرار والمهتمون من الأفراد
الآخرين المعلومات والبيانات التي يمكن أن تلبي احتياجاتهم وتشبع اهتماماتهم.
ومن خلال هذا التعريف نلاحظ، أنه لم يتطرق أو أغفل ذكر أنواع مصادر
المعرفة، وإنما ركز على عملية استثمار المعلومات للوصول من خلالها إلى المعرفة.
بينما يعرفها (عبدالقادر,
2009) بأنها الرصيد المعرفي الناتج من حصيلة البحث العلمي
والتفكير والدراسات الميدانية والتطوير والخبرات والمشروعات الابتكارية وغيرها من
أشكال الانتاج الفكري للإنسان وعبر الزمان لتتمثل جميعها في الرصيد المعرفي أو
الكم القابل للاستخدام في أي مجال من المجالات وقد قسمها إلى نوعين معرفة صريحة ومعرفة
ضمنية.
ومن خلال هذا التعريف أنه تمت الاشارة إلى أنواع مصادر المعرفة
الضمنية والمعرفة الصريحة.
وتعرفها
إجرائيا (الهزاني,
2012) بأنها الكيفية التي بها إدارة مصادر
المعرفة للمعرفة وكيفية حصولها على ما لدى الأفراد من معارف كامنة في عقولهم أو
جمع وإيجاد المعرفة الصريحة في السجلات والوثائق وتنظيمها بطريقة تسهل استخدامها
ومشاركتها بين عاملوا المعرفة بما يحقق الميزة التنافسية ورفع مستوى الأداء في
إدارة مصادر المعرفة بأفضل الأساليب وبأقل التكاليف الممكنة.
ومن خلال تعريف (Saffady) فقد عرف (الكبيسي,
2005) مصدر المعرفة بأنه ذلك المصدر الذي
يجري أو يجمع المعرفة، وأكد أن الذكاء والتعلم والخبرة أمور تحدد حدود المعرفة
للأفراد، وأن الحس يعد كمصدر من مصادر المعرفة كما ذكره ارسطو قديما.
في هذا
التعريف نلاحظ أن هذا التعريف تعريف فلسفي كون ارسطو يعتبر ان الحس نوع من مصادر
المعرفة.
أهمية أنواع مصادر المعرفة:
تكمن أهمية أنواع مصادر المعرفة من
خلال ما أشار اليه (همشري, 2013) كونها تلعب دورا مهما في تطوير
أنشطة المنظمات وذلك من خلال المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة والمتمثلة في أنواع
مصادرها الداخلية والخارجية على النحو التالي:
·
مصادر داخلية: وتشمل
الإنسان أو الفرد العامل الذي لديه معارف وخبرات متخصصة في كيفية انجاز الأعمال
التي تتطلب إبداعاً من طرفه، وفرق العمل التي تمثل مجموعة من الأفراد الذين
يتميزون بقدرات إبداعية ويعملون لابتكار معارف جديدة في مجال عملهم، والبحوث
والدراسات التي تسهم في تطوير أنشطة المنظمة.
·
مصادر خارجية: وتشمل
العلاقات المتبادلة فيما بين المنظمات، إذ تؤدي هذه العلاقات إلى تعلم كثير من
المهارات والخبرات، وكذلك المشاركة والتعلم من الأطراف الخارجية كالمنافسين أو
الزبائن أو المستفيدين أو الموردين أو الناشرين والتفاعل مع البيئة الخارجية بشكل
عام.
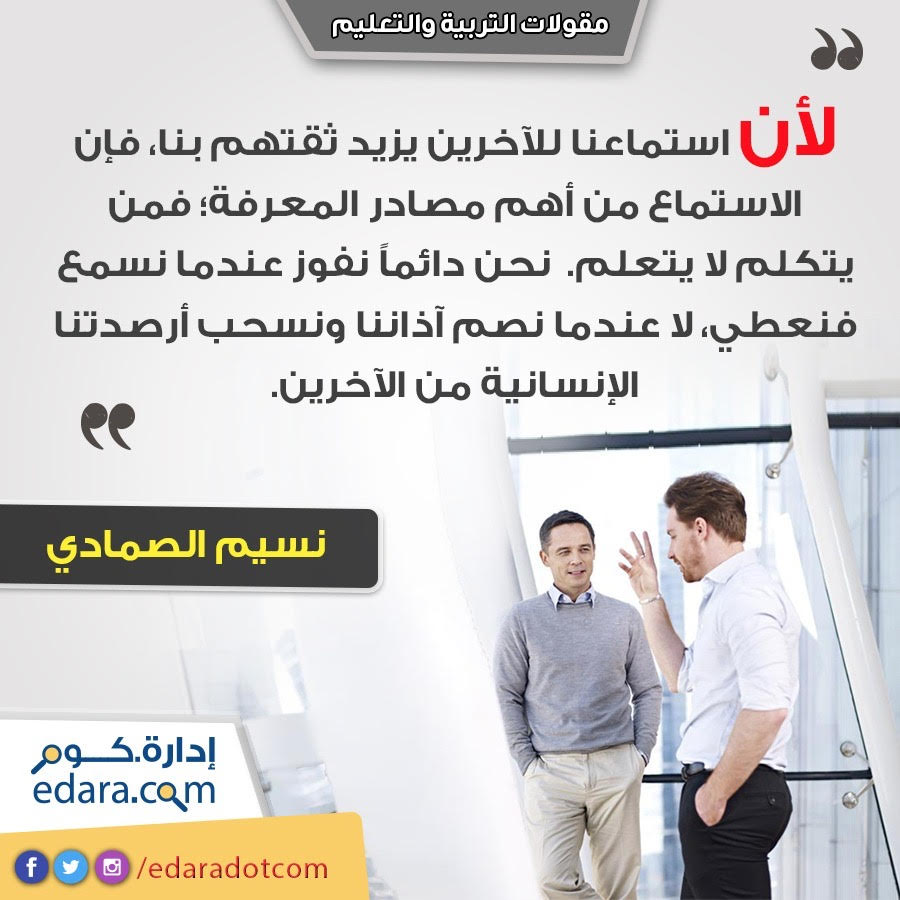
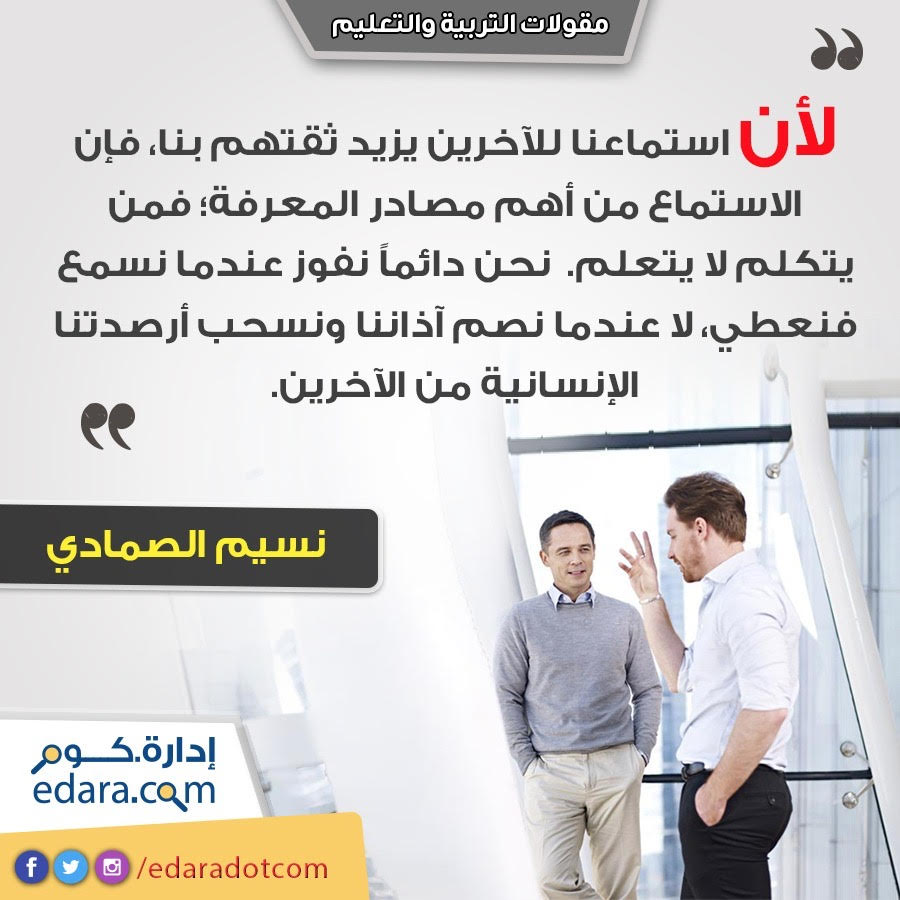
أنواع وتقسيمات مصادر
المعرفة:
تتنوع في عصرنا الحالي أنواع مصادر
المعرفة ولا يمكن حصرها، فهناك العديد منها ويمكن أن نتناول بعضها فقد طرحت (طاشكندي,
2007) بعض هذه الأنواع والتي يمكن تحديدها بالاتي:
1) الإنسان أو الفرد العامل: يعتبر الإنسان
أو الفرد العامل في أي مجال هو مصدر للمعرفة، ولكن ليس كل العاملين في محيط العمل
الإنتاجي، حيث يشمل فقط العاملين الذين لديهم معارف وخبرات في كيفية إنجاز الأعمال
ذات الطبيعة الخاصة والتي تتطلب إبداعا في العمل، وعن طريق هذه المعرفة استطاعت
شركات إنتاج السيارات مثلا: إنتاج سيارات بأفكار ومعارف العاملين ويطلق على هؤلاء
في مجتمع المعرفة برأس المال الفكري (Intellectual
capital)
ويشير في هذا المجال (CMA) أن هؤلاء الأفراد العاملين هم المسؤولين عن
تحقيق القيمة المضافة أو العائد لمنظماتهم من خلال مهاراتهم وخبراتهم.
2) فرق
العمل: إن هؤلاء
يمثلون مجموعة من العاملين ضمن مجال وظيفي معين أو مجالات مختلفة ويتميزون بقدرات
إبداعية ويعملون معا لابتكار معارف جديدة في مجال عملهم.
3) البحوث والدراسات:
وتعتبر مصدرا مهما لإنتاج
المعرفة مثال على
ذلك: التسويق وبحوث تطوير
المنتجات، حيث أنها تساهم
في إيجاد معرفة
جديدة يكون لها
دور فعال في تطوير
أنشطة المنظمات.
إن هذه المصادر الانفة الذكر تمثل
أنواع لمصادر المعرفة الداخلية للمنظمة، بالمقابل
هناك مصادر خارجية تتمثل
في العلاقة التي تجمع بين الشركات
الكبيرة مع الشركات
الصغيرة أو علاقة الشركات مع
بعضها البعض، حيث أن
هذه العلاقات تؤدي
إلى تعلم الكثير
من المهارات والخبرات.
ويضيف
(Cullen, g. B and Parboteeah K, 2005) في
تقسيمه لأنواع مصادر المعرفة من حيث الحصول على المعرفة أو اكتسابها إلى:
1- مصادر داخلية:
تعتبر المعرفة الضمنية احد أنواع المصادر الداخلية لاكتساب المعرفة وتشتمل المعرفة الضمنية على خبرات الأفراد ومعتقداتهم وافتراضاتهم وذاكرتهم وحقوقهم وفي الطلب يكون هذا النوع من المعرفة صعب النقل أو الشرح وفي الوقت ذاته قد تكون لهذا النوع منافعه الكثيرة لصالح المنظمة.
2-
المصادر
الخارجية:
وتعتبر المعرفة
الصريحة أيضا أحد أنواع المصادر الخارجية، وهناك
عدد كبير من
المصادر الخارجية التي
يمكن للمنظمة الحصول
منها على المعرفة ومن هذه
المصادر: المشاركة في
المؤتمرات والاستعانة بالخبراء
ومتابعة الصحف والمجلات
والمواد المنشورة على شبكة
المعلومات العالمية ومشاهدة
التلفزيون وأفلام الفيديو
ومراقبة الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية
والتقنية وجمع المعلومات
والبيانات من الزبائن والمنافسين والموردين والتعاون
مع المنظمات الأخرى
وإنشاء التحالفات وإقامة المشاريع المشتركة وغير
ذلك من المصادر
الأخرى.
وبالمثل قسم (الكبيسي,
2005) أنواع مصادر المعرفة الى قسمين:
مصادر خارجية ومصادر داخلية على النحو التالي:
Ø
المصادر الخارجية:
وهي تلك
المصادر التي تظهر في بيئة المؤسسة المحيطة، والتي تتوقف على نوع العلاقات مع
المؤسسات الأخرى الرائدة في الميدان، أو الانتساب إلى التجمعات التي تسهل عليها
عملية استنساخ المعرفة، ومن أمثلة هذه المصادر المكتبات والانترنت والأنترانت،
والقطاع الذي تعمل فيه المؤسسة والمنافسون لها والموردون والزبائن والجامعات
ومراكز البحث العلمي وبراءات الاختراع الخارجية، وتعد البيئة المحيطة بالمؤسسة
المصدر الخارجي للمعلومات والمعرفة، حيث يعمل الأفراد على مختلف مستوياتهم
التنظيمية ومن خلال أحد أو كل المدركات الحسية السمعية، والبصرية، واللمس، والذوق،
والشم على اكتساب البيانات من البيئة ومن خلال قدراتهم الإدراكية والفهمية مثل:
التأمل والفهم والحكم، يستطيع الأفراد معالجة هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات
وذلك من خلال الخبرة والذكاء والتفكير والتعلم، فيستطيع الأفراد تفسير هذه
المعلومات ووضعها في معنى يحولها إلى معرفة، وعلى المؤسسة أن تتوقع جميع التهديدات
المحتملة أو الفرص المتاحة لتكون فاعلة، لذا ينبغي أن تكون قادرة على البحث
والحصول على المعلومات والمعرفة من البيئة المحيطة بها والاحتفاظ بها وتطويرها.
Ø
المصادر الداخلية:
تتمثل المصادر
الداخلية في خبرات أفراد المؤسسة المتراكمة حول مختلف الموضوعات وقدرتها على
الاستفادة من تعلم الأفراد والجماعات والمؤسسة ككل وعملياتها والتكنولوجيا
المعتمدة، ومن الأمثلة على المصادر الداخلية: الاستراتيجية والمؤتمرات الداخلية،
المكتبات الالكترونية. التعلم المدرسي، الحوار، العمليات الداخلية للأفراد عبر
الذكاء والعقل والخبرة والمهارة، أو من خلال التعلم بالعمل أو البحوث وبراءات الاختراع
الداخلية.
من خلال ما تم
سرده فيما يتعلق بأنواع وتقسيمات مصادر المعرفة، وبالرغم من وجود بعض التباين لدى
الباحثين بعرض تلك التقسيمات، إلا أننا نرى أنها تصب في مصب واحد، وهو التركيز على
العنصر البشري بالدرجة الاولى حيث، أن العنصر البشري يمثل راس المال الفكري في
تطوير عمليات المنظمة.
المنظور الفلسفي لأنواع مصادر المعرفة:
سنتناول في هذه الجزئية لأنواع مصادر المعرفة من المنظور الفلسفي،
حيث قسم (تر,
2017) مصادر المعرفة إلى
ثلاثة مصادر كما ذهب إلى ذلك الفلاسفة: العقل والتجربة والحدس وتفاصيل ذلك كما
يلي:
a) العقل: العقل هو الأداة الرئيسية للمعرفة
عند أنصار المذاهب الفلسفية العقلية، حيث يرون أن في العقل مبادئ عقلية و حقائق
كلية ندرك بواسطتها طبيعة الأشياء، وهي عبارة عن نماذج عامة مجردة تقابل الأشياء، والحقيقة
تكمن في تطابق ما في الذهن مع ما في الواقع, و يعد أفلاطون و دیکارت من أهم أنصار
هذا الاتجاه حيث، يرى أفلاطون أن الحقيقة لا تستمد من الحواس إنما من المثل والأفكار
المفارقة للعالم الحسي الموجودة في عالم المثل و نصل إليها بالإدراك العقلي ومن ثم
تنظيم الأشياء الحسية بناء عليها, حيث يری دیکارت أن الحقائق موجودة في العقل بشكل
فطري و تنمو و تتطور مع نمو الإنسان و تفكيره فالإنسان لا يتعلم شيء جديد بل يكتشف
الحقائق الموجودة.
b) التجربة: يذهب أنصار الاتجاه الوضعي و
التجريبي إلى أن المعارف ليست فطرية بل يكتسبها الإنسان عن طريق التجربة من خلال
الاتصال بالعالم الحسي منذ ولادته ثم تتطور مع تطور تفكيره من الحسي إلى المجرد، ومن
أبرز ممثلي الاتجاه التجريبي (John Locke) حيث أنكر
وجود أي معرفة فطرية سابقة في العقل، وذهب إلى أن مصدر المعرفة الإحساس و
الاستبطان أي جميع الأفكار الأولية تنشأ عن الحواس و تتوزع هذه الأفكار على أربعة
أنواع هي:
1)
أفكار صادرة عن حاسة واحدة
مثل: اللون والصوت.
2)
أفكار صادرة عن حاستين أو
أكثر مثل: الامتداد والكمية والحركة.
3) أفكار صادرة عن الاستبطان مثل الإدراك والتفكير والانفعال.
4)
أفكار
صادرة عن الإحساس والاستبطان مثل الوجود و الحرية.
c) الحدس: معرفة مباشرة نحصل عليها دون عناء
وله ثلاثة أنواع:
1- الحدس التجريبي: ويقسم بدوره إلى قسمين:
أ-
حدس
حسي: نحصل عليه بواسطة الحواس الخمس وهو أولى درجات معرفتنا بالعالم الخارجي.
ب- حدس نفسي: المعرفة المباشرة لما يدور داخل الإنسان من
انفعالات وعواطف وأفكار وحزن وفرح.
2- حدس عقلي: وبه نعرف المقولات العقلية مثل: قانون الهوية والسببية
والمفاهيم الرياضية مثل: النقطة والمستقيم والعدد.
3- حدس مبدع: وهو أعلى درجات الحدس يعتمد عليه الفلاسفة في
وضع مذاهبهم وأفكارهم ويعتمد عليه الأدباء والشعراء في إبداعهم.
الخاتمة:
فيما سبق تطرقنا بالشرح لأنواع مصادر المعرفة وذلك من خلال المحاور
التالية:
ü
مفهوم أنواع مصادر المعرفة.
ü
أهمية أنواع مصادر المعرفة
ü
أنواع وتقسيمات مصادر المعرفة.
ü
المنظور الفلسفي لأنواع مصادر المعرفة.
ومن خلال ما تم شرحه نخلص إلى بعض الملاحظات ومنها:
بعض التعاريف التي تطرقت الى أنواع مصادر المعرفة، لم تتطرق إلى ذكر
أنواع مصادر المعرفة صراحة، وإنما ركزت على عملية استثمار المعلومات للوصول من
خلالها إلى المعرفة، وفي المقابل هناك تعريفات تعرضت لأنواع مصادر المعرفة صراحة، وعلى
الجانب الاخر هناك تعريف نحى منحى اخر، حيث تناول تعريف انواع مصادر المعرفة من
الجانب الفلسفي.
اتفق جميع من كتب عن أنواع مصادر المعرفة على أن هناك مصادر داخلية
للمنظمة تتمثل في المعرفة الضمنية، وبالمقابل هناك مصادر خارجية تتمثل في المعرفة
الصريحة، وأن محور العملية برمتها تصب في مصب واحد وهو التركيز على العنصر البشري
بالدرجة الاولى، كونه يمثل راس المال الفكري في تطوير عمليات المنظمة واتخاذ
القرارات المناسبة.
المراجع:
المراجع العربية:
الكبيسي,
صلاح الدين (2005). ادارة المعرفة. القاهرة: منشورات المنظمة العربية للتنمية
الادارية.
الهزاني, نورة ناصر (2012). المفاهيم
الاساسية لإدارة مصادر المعرفة. Retrieved March 15, 2018, from
https://nalhazani2012.wordpress.com
تر, سامي. (2017). مصدر المعرفة عند الفلاسفة.
Retrieved March 16, 2018, from https://lesociologie.blogspot.com/2017/03/blog-post_46.html
جيدوري, بشار (2017). مصادر المعرفة.
Retrieved March 16, 2018, from http://www.civicegypt.org/?p=73722
طاشكندي, زكية ممدوح قاري عبدالله (2007). إدارة
المعرفة وأهميتها ومدى تطبيق عملياتها من وجهة نظر مديرات الادارات والمشرفات الاداريات
بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة. جامعة أم القرى.
عبدالقادر, أمل حسن (2009). أخصائي المعلومات
وإدارة المعرفة. الدار البيضاء: ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر العشرين للإتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات ، الدار البيضاء- المغرب.
نصر, محمد علي (2001). تفعيل بعض مخرجات
التعليم الجامعي في عصر تعدد مصادر المعرفة. ورقة
مقدمة إلى المؤتمر القومي السنوى الثامن لمركز تطوير التعليم الجامعي.
القاهرة.
همشري, عمر أحمد (2013). إدارة المعرفة
الطريق إلى التميز والريادة. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.
المراجع الاجنبية:
Cullen, g. B and Parboteeah K, P. (2005).
Multinational Management.
تعليقات